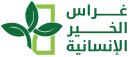المدارس في سوريا: واقعٌ صعب ومستقبلٌ ينتظر الأمل
مقدمة
منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام القمعي الطائفي في سوريا عام 2011، شهد قطاع التعليم في سوريا انهياراً كبيراً، ترك تأثيرًا عميقًا على جيلٍ كامل من الأطفال والشباب، وغيّر ملامح المدارس التي كانت يومًا ما أماكن للعلم والتربية والنمو. تحوّلت آلاف المدارس إلى أطلالٍ مهجورة، أو ملاجئ للنازحين، أو حتى مواقع عسكرية، بينما واصل الأطفال السوريون رحلتهم الصعبة في البحث عن فرصة للتعليم وسط الركام والفوضى.
في هذا المقال، نسلّط الضوء على واقع المدارس في سوريا، التحديات التي تواجه العملية التعليمية، جهود التعافي، وآفاق الأمل التي تلوح في الأفق رغم العتمة.
أرقام صادمة تعكس حجم المعاناة
وفقًا لتقارير المنظمات الدولية، فإن أكثر من 2.4 مليون طفل داخل سوريا هم خارج المدرسة بسبب تداعيات الحرب المدمرة على المدارس، والنزوح، والفقر، وعمالة الأطفال. وقد تعرضت أكثر من 7000 مدرسة لأضرار مباشرة أو جزئية أو خرجت عن الخدمة تماماً بسبب القصف أو الاستخدام لأغراض غير تعليمية.
بعض المدارس التي ما زالت تعمل، تفتقر إلى أبسط المقومات التعليمية، كالكهرباء، والمياه، والتدفئة، والمرافق الصحية، ناهيك عن نقص الكوادر المؤهلة والكتب المدرسية والمناهج الحديثة. ويعيش المعلمون والطلاب على حد سواء تحت ضغوط نفسية ومعيشية هائلة، تجعل من العملية التعليمية تحديا يوميا، مما سبب توقف العملية التعليمية أحياناً.
بين النزوح والفقر: الأطفال يدفعون الثمن
خلفّ دمار المدارس والمرافق التعليمية، يكمن دمار اجتماعي عميق. النزوح المتكرر والتطويل أدى إلى انقطاع آلاف الأطفال عن التعليم والمدارس، وتوجه كثير من الأطفال إلى العمل لمساعدة أسرهم الفقيرة والانخراط في أعمال صعبة ومتعبة لتأمين لقمة العيش.
يعيش بعض الأطفال في مخيمات لا تتوافر فيها مدارس أساساً، أو في مناطق نائية منعزلة لا يمكنهم الوصول فيها إلى الصفوف الدراسية. وفي بعض الأحيان، يُجبر الأطفال على المشي لساعات للوصول إلى أقرب مدرسة، ما يشكّل خطراً على حياتهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي استمرت طويلاً.

المعلمين السوريين: أبطال في الظل
في ظل كل هذه الظروف الاستثنائية خلال الحرب الطويلة، يبقى المعلم السوري العنصر الفاعل الأساسي في حصول الطالب على حقه بالتعليم بالحد الأدنى، حيث عمل المعلم السوري بكل جهد وأخلاص وتفاني رغم تدني الرواتب، وغياب الدعم، والتحديات الأمنية. كثير من المعلمين فقدوا منازلهم، وعائلاتهم، ومع ذلك واصلوا أداء رسالتهم النبيلة السامية.
معظم المعلمين يعملون تطوعاً، أو مقابل أجر رمزي، في مبادرات تعليمية محلية أو مراكز مجتمعية صغيرة. دورهم في الحفاظ على الحد الأدنى من النظام التعليمي لا يقل أهمية عن أي تدخل دولي، بل هو جوهر استمرارية الأمل للعملية التعليمية في سوريا.

يمكنكم دعم الطلاب في مدرسة عائشة أم المؤمنين في الشمال السوري والإطلاع على تفاصيل أكثر عن هذا المشروع الخيري للأيتام عبر الرابط التالي
جهود الإغاثة والتعليم البديل
رغم كل شيء، هناك جهود تُبذل من قبل منظمات إنسانية، دولية ومحلية، لإعادة بناء المدارس أو ترميمه، أو توفير تعليم بديل عبر المراكز المجتمعية، الصفوف المؤقتة، أو برامج التعليم عن بُعد.
بعض المبادرات قدمت دورات دعم نفسي اجتماعي للأطفال المتضررين، أو وفرت حقائب مدرسية ومواد تعليمية. وتم إنشاء “مدارس خيام” في بعض المخيمات، وإن كانت تفتقر للبنية التحتية، إلا أنها وفرت بيئة مؤقتة للتعلم.
كذلك، تحاول بعض المنصات الرقمية سد الفجوة عبر توفير محتوى تعليمي رقمي باللغة العربية، خصوصًا في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
أمل في المستقبل… رغم الجراح
وسط هذا الظلام، هناك دائمًا شموع تضيء الطريق. فالأطفال الذين يذهبون إلى مدارس مدمرة أو امراكز التعليم المؤقت في المخيمات، حاملين دفاترهم وأقلامهم، هم دليل على قوة الأمل والإصرار على الاستمرار في التعليم.
وقد عبّرت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن التزامها بجعل “التعليم في الطوارئ” أولوية، وتخصيص مزيد من الدعم لإعادة بناء النظام التعليمي في سوريا.
ومع تحسن نسبي في بعض المناطق، بدأت تظهر مبادرات لإعادة تأهيل المدارس، وتدريب المعلمين، وتحديث المناهج.
لكن الأمل وحده لا يكفي، إذ لا بد من إرادة سياسية، واستقرار أمني، وشراكة دولية حقيقية لإعادة بناء قطاع التعليم من جديد.

الخاتمة: التعليم… حقٌ لا يُؤجل
المدارس في سوريا اليوم ليست مجرد مبانٍ تحتاج إلى ترميم، بل هي كيان اجتماعي وثقافي وتعليمي يعكس مستقبل البلاد والإزدهار والنمو. فكل طفل لا يحصل على التعليم اليوم، يجعل مستقبل سوريا مهدد، ويحرم أجياله من الحلم والأمل.
إن استعادة التعليم في سوريا هي استعادة للكرامة، وللإنسان، وللوطن. وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة، والمجتمع الدولي، والمجتمعات المحلية، لأن الطفل السوري يستحق أن يجلس في صفٍ آمن، ويتعلم، ويضحك ويلعب، ويحلم مثل أي طفل آخر في هذا العالم.